مَن منكم حكايته تشبه حكايتي؟
مَن منكم غامر وراهن وعاد بالعمر بدون أن يوقفه، إلى حقبةٍ كان قد عاشها وقرّر أن يعيشها مرّة أخرى؟
إنّها حكاية طالبةٍ لا تشبه الأخريات.
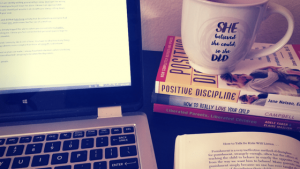
عدتُ إلى لبنان،
بعد سبعة عشر عاماً على التخرج من كليّة الاعلام، بعد سبعة عشر عاماً على الزواج وتأسيس عائلةٍ أفخر بها وأهتمّ لها وأعيش من أجلها.
بدأ الحلم المستجدّ يصبح واقعاً أعيشه.
عدتُ إلى لبنان لِأجلس من جديد على مقاعد الدراسة.
والتحقتُ بمدرسة الترجمة في جامعة القدّيس يوسف بهدف إضافة أرصدةٍ جديدةٍ إلى سجلّي التعليمي.

سأعترف لكم بسرٍّ، أشكُّ في أن تنالوا ترفَ قراءةِ سرٍّ على شاكلته إلّا نادراً: في يومي الاوّل في الجامعة، كنتُ على ثقةٍ كبيرة بأنني أستطيع أن أخفي عمري، ولكنّي اكتشفتُ أنّ القطارَ فاتني وأنا ما زلتُ واقفةً مكاني مستغربةً كيف استطاعوا أن يقرأوا عمري وأن يعرفوا بأنّي « مدام ».
كنتُ أعودُ كلّ يومٍ إلى البيت وأنظرُ في مرآتي لأتبيّن َ ما الذي تغيّرَ ولم ألحظْه، ولكن دون جدوى!
هل هي مغالاةٌ في الثقة بالنفس أم رفضٌ لعمرٍ يمرُّ لا أتذكّرُهُ إلّا عندما أنظرُ إلى أولادي، أنا، تلك الفتاة التي ما زال أسلوب حياتها، وهندامها من الجينز إلى التيشرت، مروراً بطريقة تفكيرها وصولاً إلى قلبها، يدلّ على انتمائها لجيلٍ آخر وعمرٍ افتراضيّ آخر.
نظرات ، أحاديثٌ، فصداقات
لا يمكن أن أنسى اليوم الاول، كانت الحصّةُ الاولى في القاعة ٦٢٠، جلستُ في جهةٍ، والاخرياتُ في جهةٍ أخرى، تمنيّتُ لو أستطيعُ قراءةَ نظراتِهنَّ وتساؤلاتهنَّ، تمنّيتُ لو أستطيعُ سماعَ الأحاديث الجانبية التي دارتْ بينهُنّ.
وما هي إلا أيّام قليلة وانكسَر الحاجزُ بيننا، تعارفنا وتبادلنا الأحاديث، وأصبحن يعرِفْنَ سلام وخططَه الجامعيّة، وغدي وقصصَه الهولييوديّة وجود وأخبارَ « صغير البيت ».
بفضل مَن لا أدري تحديداً!
ولكن، ما أثق به تمام الثقة هو أنّ نجاحَ العلاقاتِ الاجتماعيّة وليدُ جهدِ الأطراف مجتمعة.
ما أعرفه هو أنّ الحياة كانت كريمةً معي ووضعت أمامي قلوباً محبّة وصافية، لكلّ منها إمضاءٌ خاصٌّ في سجلٍّ لم يتجاوز عمره السنتين.
فكما لكلّ مترجمة محرّرة في الدفعة ٢٠١٩ أسلوبها، كذلك لها بصمتها في ذهني وقلبي.
أنا من نضجتْ كفاية على عمر الأربعين لتتفوّق عليهنّ بأشواطٍ عديدة في مدرسة الحياة.
« تفضّلي مدام كيف فيّ ساعدك »
اسمحوا لي أن أعترف لكم بأمر آخر، هل تعلمون أنّه، وكما للتقدّم في العمر سيئات، كذلك له حسنات كثيرة؟
للمصعد كلّ يومٍ ألف حكايةٍ وحكاية، زميلاتي يستفدن من تواجدي وينتظرن خلفي بغية الصعود ورائي، أنا من أعامَل على أنّي وبلا شك، مُدرِّسة أو موظّفة، فالطلّاب يفسحون لي الطريق، والموظّفون يبتسمون لي، وأقرأ على وجوههم علامات الاستفهام والتساؤل.
وعندما أكون على عجلة من أمري وأقصد المكتبة للطباعة، ألقى معاملةً خاصّة وسرعةً في الخدمة.
حتّى موظّفة الكافتيريا لا ترحمني وتناديني دائماً قائلةً: « تفضّلي مدام كيف فيّ ساعدك ».
وبين المزاح والجدّ واللذة والتعب، مرّت السنتان.
ستنتهي هذه الحكاية وتبقى في ذهن مَن سيقرأ سطورَها والاهمّ في ذهن من سيقرأ بين سطورِها، عمراً كَتَبتْه تلميذةٌ أربعينية وتجربةً خطّتها بمثابرةٍ وعزم، لتبدأ حكايةٌ جديدةٌ في زمنٍ ما وفي مكانٍ ما…



